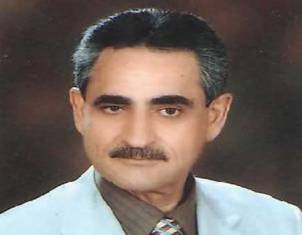![مدرسة]()
الفصل العاشر
مدارس حلب القديمة داخل وخارج السور
كانت لحلب كمدينة إسلامية آهلة وهامة منذ قديم الزمان مدارس تقع جميعها قرب الجوامع بغض النظر عن المستوى البدائي للعلوم التي كانت تدرس للذكور فقط حتى السنوات الأخيرة من القرن 19 عندما افتتحت مدارس حكومية رسمية بمراحلها الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وكان جميع معلمي المدارس في الماضي من الشيوخ الذين كانت لهم رواتب شهرية عدا هدايا الطلاب. وكان الطلاب يقرأون دروسهم سوية وبصوت عال يسمع من بعيد. ولا يزال بعض الطلاب في أحياء عديدة يذهبون إلى مدرسة الحي الدينية عوضاً عن الابتدائيات الرسمية رغبة منهم بالحصول على مرتبة الإمام أو الشيخ. ويُعمل بهذه الطريقة العربية للقراءة بشكل غريب في الحضانات السريانية في حي الصليبة. ويميل التلاميذ أثناء القراءة إلى الأمام والخلف كما يفعل الكبار أثناء قراءة القرآن الكريم. ولم يكن مسموحاً لطلاب مدارس الحي بالخروج إلى الشارع لوحدهم في الماضي فقد كان الخدم يصطحبونهم من وإلى المدرسة. وحتى قبل قرنين كان المعلمون يزورون المنازل للتأكد من حسن سلوك الطالب وكانت هذه العادة تسرّ الأمهات وكن يهددن الأولاد عند عدم إطاعة أوامرهن بأنهن سيذهبن إلى الشيخ للشكوى ضدهم. كانت هناك حتى القرن 18 مدارس دينية لتعليم التلاميذ الأكبر سناً تتألف من غرفة مطالعة ومكتبة وغرفة مخصصة للشيخ وبعض غرف النوم للتلاميذ. وكان للتلاميذ راتب شهري بسيط في القرون المبكرة وكان عدد هذه المدارس أكبر كما سنرى وأحوالها الدراسية حسنة. وبعد الاستيلاء على أوقاف هذه المدارس وحرمانها بالتالي من الدخل عبر الزمن تحول معظمها وخاصة بعد فتح المدارس الرسمية إلى أمكنة مهملة خربة وزال أثر العديد منها. ويقول الدكتور رسل القنصل البريطاني في حلب في عام 1765 حول هذه المدارس: ((المدارس مراكز سفسطة وأوهام بدلاً من العلم. والمداومون على مناهجها يأتون من الطبقات الدنيا. وللأفندية الصغار معلميهم الخصوصيين ومواد التدريس الرئيسية هي قواعد اللغة وعلم اللاهوت ومعظم المدارس والمساجد شيدها الأغنياء انطلاقاً من شعور التقوى أو للتكفير عن ذنوبهم. وكان للعثمانيين دافع آخر لبناء هذه المنشآت وهو تعيينهم مشرفين عليها لتأمين عائلاتهم بدخل معين بموافقة الباب العالي)).
يصف المؤرخ ابن الشداد مدارس حلب ويتبعه ابن الشحنة فيصفان مدارس حلب الأولى المبنية داخل أسوار المدينة على الصورة التالية: المدارس داخل الأسوار – المدرسة الزَجّاجية:
هي أولى المدارس التي شيدت من قبل صاحب حلب الأمير بدر الدولة أبي الربيع سليمان بن عبد الجبار بن أورتوق بين عامي 1116-1117م. ولكن في كتابة موجودة على المدخل نجد تاريخ 1124م. وعندما بادر الأمير لبناء هذه المدرسة الأولى عارضه الحلبيون لأن معظم المسلمين في حلب في ذلك الوقت كانوا من الشيعة. وكان هؤلاء يهدمون ليلاً ما بني نهاراً يومياً تقريباً. فغضب الأمير بدر الدين جداً فجاء بأبي إبراهيم الحسيني بن علي بن شريف زهرة للإشراف على البناء ومنع السكان من هدم الأقسام المبنية. وقبل هذه الأحداث بوقت طويل كان جميع المسلمين الحلبيين من السنة الحنفيين حتى وصل إلى حلب رجل دين يدعى شريف أبو إبراهيم الممدوح واعتنق بعضهم المبدأ الشيعي والقسم الآخر المبدأ الشافعي. وقد أُكره الشريف على القبول بالإشراف على بناء المدرسة. وكان لرجل الدين هذا تأثير كبير على سكان حلب بسبب رزانة عقله وثباته وشخصيته القوية وكان الجميع ينتظرون مشوراته وكانت له حظوة كبيرة لدى الحكام. وعندما سار الأمير زنكي نحو مدينة الموصل في عام 1145م اصطحب معه شريف الممدوح حيث توفي الشيخ. وعندما كان الأمير حاكم حلب في عام 1128م نقل رفات والده أقسنقر إلى المدفن الواقع على الجهة الشمالية لهذه المدرسة. ولكي يُقرأ القرآن في مدفن والده خصص له أوقافاً. زالت هذه المدرسة في القرن 15 وشيدت على أنقاضها بيوت.
يروي المؤرخ أبو الدر في الجزء الرابع والصفحة 250 من كتابه مايلي:((سميت المدرسة باسم السوق التي شيدت فيها حيث كانت معامل الزجاج في وقت ما. وعندما حُفرت أساسات الحمام ظهرت آثار أنقاض المعامل. وهذه المدرسة التي كانت الأولى بين المدارس الدينية التي شيدت في حلب كانت تدعى “المدرسة الشرفية” سابقاً باسم بانيها شريف الدين عبد الرحمن بن العجمي. وقد علمت حول ذلك من معلمي ابن الضياء ولكنني قرأت في تاريخ بن خالليقان بأن “بانيها كان أمير حلب أبو الربيع سليمان بن عبد الجبار”. ويقول أيضاً كمال الدين بن العديم في “بغية الطلب في تاريخ حلب” بأن “بدر الدولة ابتنى هذه المدرسة التي تسمى باسم ابن العجمي في سوق الزجاجين في حلب واستخدم مواد البناء من أنقاض كنيسة تقع في حي الطحانين”. وبدر الدولة هذا هو سليمان الذي جاء ذكره. ويُذكر في كتاب “تاريخ الإسلام” بأن المدرسة شيدت من قبل عبد الرحمن بن العجمي الذي جاء ذكره وخصص لها أوقافاً. ويذكر ابن صبحي بدوره المدرسة قائلاً:”بنى مدرسة في حلب تُعرف باسمه”. وهناك مصدر آخر أيضاً يقول:”أمضى نور الدين شتاء عام 5631 عبري=167-168 هـ في قلعة حلب وكان شيراكوه وصلاح الدين بصحبته بينما نزل عماد الدين في مدرسة ابن العجمي”. ويقول ابن العساكر بدوره:”وصل المرادي إلى حلب وقام بالتدريس في مدرسة ابن العجمي”. ولكن عندما وصل المرادي لم تكن المدرسة مبنية بعد. ويتابع ابن الدر قائلاً بأن “المدرسة منشأة كبيرة لها إيوان يعتبر أحد عجائب الدنيا كذلك قاعة باهرة للصلاة ورواق على جهتها الشمالية وأرضيتها مبلطة بالمرمر الأبيض والأسود. وقد أخذ حاكم حلب قسماً كبيراً من أعمدة المدرسة وصنع منها قنابلاً لضرب القلعة لكن هجومه فشل. وقد جاءت الكتابة الكوفية التالية على جدار المدرسة:”انتهى البناء في علم 516(1123م). ويقول ابن الشداد:”والجدار الشمالي الذي كان في حال شبه خراب أعيد بناؤه. وتعود هذه الكتابة إلى البناء القديم. ولهذه المدرسة باب صغير على مدخله الرئيسي كان مخصصاً للمعلمين. وكان مؤسسها قد أوقف قرية الكويرس لتأمين احتياجاتها المختلفة وكانت في حال جيدة ومزدهرة حتى مجازر تيمورلنك فدُمرت بعد ذلك بالكامل وبقي أيوانها فقط. وقد أزال الأمير علاء الدين بن الشيباني أساساتها لأن الرسول r أمره بذلك في حلمه. وقد قدم علاء الدين معلومات لحاكم المدينة وقام بحفر الأساسات بمساعدته ولكنه هجر المشروع في نهاية المطاف. وعندما وصل ابن الضياء إلى حلب بعد اجتياح تيمورلنك اقترحوا عليه تشييد المدرسة على مراحل تدريجياً فرفض ولكنه ندم على فراش الموت. والمدرسة اليوم هي عبارة عن كتلة أنقاض)).
المدرسة العصرونية – كانت المدرسة قصراً لأبي الحسن علي بن أبي الدرية وزير المرداسيين حوّله نور الدين إلى مدرسة بعد أن آل إليه العقار بالطرق القانونية. وكان الوزير قد بنى طوابق خاصة لعلماء الشريعة الذين وظفوا كمدرسين في عام 1156م ولم يكتف بذلك فجاء من منطقة سنجار الجبلية إلى حلب بشيخ كان أحد الحقوقيين المرموقين في عصره يدعى الإمام محمد وكان شافعياً وأصله من منطقة الموصل. وبعد حلوله في المدينة عُين مدرساً للشريعة ومديراً لهذه المدرسة. ولأنه كان أول معلميها فقد سميت باسم هذا الشيخ. ولرجل الدين هذا أبحاث عديدة حول المدرسة الشافعية كذلك عن حقوق الوراثة. ويمكن الدخول إلى هذه المدرسة بدرج لكن هناك مدخل ثان على الجهة الغربية منها. وللمدرسة مدخل خاص بالمعلمين. وقد خصص مؤسس المدرسة أوقافاً لها وهي عبارة عن حوانيت وقرى تقع داخل المدينة وضواحيها. وبعد تخريبات تيمورلنك جاء الملك المؤيد إلى حلب ورمم السوق التي تقع فيها الدكاكين المخصصة للمدرسة وقسمها إلى وقفين:نصفها لهذه المدرسة والنصف الآخر لمدرسة القاهرة. وعدا هذه المدرسة شيد نور الدين مدارس أخرى في منبج وحماه وحمص وبعلبك ودمشق وأسند مهمة تعيين المعلمين لها إلى الشيخ السنجاري الذي استمر في عمله في المدرسة حتى عام 1175م وهو تاريخ سفره إلى دمشق حيث توفي.
المدرسة النفرية – لا يُعرف باسم مَن كانت تدعى المدرسة.
المدرسة النورية – تأسست في عام 1150م من قبل نور الدين.
المدرسة القوّامية – تأسست قرب حي الفرافرة على الجهة الداخلية لباب الأربعين قرب سبيل الملك العادل.
المدرسة الصاحبية – أسسها القاضي بهاء الدين أبي المحاسن المعروف بابن شداد عام 1205م.
المدرسة الظاهرية – سُميت لاحقا” ب”المدرسة السلطانية”وكانت تخص الشافعيين والحنابلة وتقع على الجهة المقابلة للقلعة. أسسها الغازي لكنه توفي في عام 1217م فقام شهاب الدين طغرل أتابك الملك العزيز بإتمامها في عام 1224م. والمدرسة بناء متين جداً شيدت بأحجار كبيرة ومحرابها آية في الجمال والكمال فقد بني بالمرمر. وعندما دمر تيمورلنك حلب رغب بنقل هذا المحراب إلى وطنه ولكن عندما أعلموه بعد إمكانية ذلك لأسباب فنية تخلى عن فكرته وبقي المحراب في مكانه. وتحتوي المدرسة على غرف عديدة وكان هناك درج يؤدي إلى بركة الماء.
المدرسة الأسدية – أسسها أسد الدين شيراكوه ولكنها في حالة خراب كالعديد من المدارس وكانت تقع داخل باب قنسرين في حي الرحبة ولها إيوان كبير وغرف للمعلمين وبركة ماء. ويؤكد أبو الدر(الجزء-4 صفحة 259) بأنه لم يتمكن من قراءة الكتابة الموجودة على لوح من المرمر في مكان عال من الإيوان التي تحتوي على تاريخ إنشاء المدرسة. وكان للمدرسة وقف هام في دمشق وعقارات آخرى في حلب وهي عبارة عن أراضي في قرية الشيخ سعيد وحوانيت في بانقوسا ودكان في سويقة الحاتم. ويقال بأن الدروس كانت تجري تحت ضوء الشموع قبل اجتياح تيمورلنك حتى بعد صلاة الفجر ثم يخرج الطلاب من المدرسة نحو باب قنسرين إلى مدارس أخرى خارج سور المدينة للاشتراك في دروسها أيضاً.
المدرسة الرفاعية – بناء على تأكيد أبي الدر(الجزء-4 ص 41-42) شيد المدرسة زكي الدين أبي القاسم عباد الله قرب دير شمس الدين وابتنى مدرسة أخرى مشابهة في دمشق. وقد تضررت المدرسة كثيراً وهدّ سقفها أثناء اجتياحات تيمورلنك للمدينة. وعندما سمّي الأشرف حاكماً لحلب أمر بترميم المدرسة وبناء السقف وباشرت الدروس. وللمدرسة أوقاف في القرى المحيطة.
المدرسة الشعيبية – كانت المدرسة مسجداً في بداية فتح العرب للمدينة. وعندما احتل نور الدين حلب وأسس مدارس في كل مكان جاء بعالم التشريع الشيخ شعيب الأندلسي إلى حلب واستملك المدرسة وسميت باسمه ودرّس فيها حتى وفاته عام 1200م. وقد تحولت المدرسة إلى جامع لاحقاً حيث كانت تقرأ خطبة الجمعة. وكان للجامع مئذنة صغيرة.
المدرسة الشرفية – أسسها الشيخ الإمام شرف الدين أبي طالب المعروف بابن العجم الذي صرف مبلغ 400,000 درهماً في تشييدها ثم خصص لها أوقافاً عديدة هامة. وقد قام ابنه محي الدين محمد بالتعليم في المدرسة حتى استشهاده أمام المغول.
المدرسة البدرية – أسسها بدر الدين وهي في حال خراب كامل ولم يبق منها سوى المدخل. وقد شيدت في المدة الأخيرة بيوت على أنقاضها.
المدرسة الزيدية – باشر إبراهيم بن إبراهيم المعروف باسم ابن زيد الكيال الحلبي ببناء المدرسة وانتهى العمل عام 1257م. بناء على أقوال (أبي الدر الجزء-4 ص 318) كانت المدرسة تقع داخل باب أنطاكية في حارة “درب الزيدية” وفي هذا الزقاق أيضاً كان هناك مسجد تحت قنطرة. وقد تم تحويل المدرسة ذات الطابقين بعد فترة إلى دار للسكن وبيعت لاحقاً ولكن رئيس قضاة المدينة استردها من اللصوص وخصصها للعبادة. وكان قرب المسجد سبيل ماء.
المدرسة السيفية – أسسها الأمير سيف الدين علي بن علم الدين سليمان بن جاندار في عام 1221م وكانت مخصصة للشافعيين والحنفيين وتقع بناء على تأكيد أبي الدر (الجزء-4 ص 346) خارج باب قنسرين. ويقع جامع إلى جانب المدرسة وكان مدفناً في الأصل ومخصصاً لبني أبي جراد. وكان قبر القاضي أبي الفضل ووالده وأسلافه شيد في هذا المكان. وعندما هدم سيف الدين هذا المدفن وابتنى مسجداً في موقعه تم نقل رفات جميع هؤلاء إلى جبل الجوشن. وكانت المدرسة السيفية واسعة وتحتوي على غرف عديدة للمعلمين ومئذنة متينة وصهريج. والمدرسة في حالة خراب الآن ولا يوجد سكن حولها.
المدارس الشافعية خارج سور المدينة
المدرسة الظاهرية – تأسست من قبل الملك الظاهر غازي في عام 1220م. وكان على الجهة المقابلة من المدرسة مدفن لقبور الملوك والأمراء. وكانت المدرسة تقع خارج باب المقام ويعمل فيها 15 مدرساً فقيهاً وعالم شريعة ومقرئ خاص. ومن أوقاف المدرسة الحديقة المجاورة وحمام وسوق في المدينة. وكانت المدرسة متينة البناء تحتوي على غرف عديدة وبركة ماء ويقال بأنها دافعت عن نفسها أثناء الهجوم المغولي.
المدرسة الهروية – أسسها الشيخ أبي الحسن وكانت مدرسة عامرة حتى الاجتياح المغولي ولكنها خُرّبت جزئياً وأصبحت مهجورة. ويروى بأن الشيخ كان مدفوناً في مدفن قرب المدرسة يشبه الكعبة بشكله الخارجي. وكانت جدران المدفن تحتوي على كتابات حول أحكام قضائية وأمثلة شعبية ونصوص عتاب. ويقع بئر على الجهة الخارجية للبناء ويعتقد أن إبراهيم قام بحفره.
مدرسة الفردوس – شيدتها الأميرة ضيفة خاتون بنة الملك العادل وهي من أهم مدارس حلب وأكبرها وفيها حتى يومنا هذا مدفن يجذب إليه عدد كبير من المقرئين وعلماء الشريعة والصوفيين.
المدرسة البولدقية – شيدها بولدوق أحد أشهر أمراء الغازي وهُدَّت في عام 1615 من قبل شخص من الرها يدعى الخواجة بكر فقد كان تاجراً يقطن في حلب وله مكانة عالية فيها. وقد أوكله أحمد باشا المكنّى بابن الأكمكجي لبناء “قصر السعادة” فقام هذا بتشييده بأحجار هذه المدرسة.
المدرسة القيمرية – شيدها أبو الحسن في عام 1249م وهي في حالة خراب تام الآن. ويؤكد أبو الدر(الجزء-4 ص 350):((تقع المدرسة خارج المدينة قرب أفران الكلس وكانت لها شهرة كبيرة في الفترة الأولى ولكنها فقدتها لاحقاً. شيدها الأمير حسام الدين بولدوق ولها أوقاف. وقد جاء على مدخلها الكتابة التالية:”المدرسة وقف مخصص لصالح الحقوقيين والطلاب الذين يدرسون الحقوق الشرعية حسب مدرسة الإمام الشافعي”.
مدرسة الشيخ أبي بكر
مدرسة معروفة من قبل جميع الحلبيين. أسسها شمس الدين أبي بكر محمد بن أبي صالح عبد الرحمن بن العجمي في عام 1198م ودفن فيها مع جميع أقاربه. وتعود المدرسة للشافعيين والحنفيين والمالكيين. والإيمان كبير جداً بهذا المزار المشهور حتى الآن لدرجة أن المرضى يعالجون حرارتهم المرتفعة بترابه. وكانت المدرسة قريبة لسور حلب القديم من جهتها الشرقية وكان لإيوانها نافذة تطل على خندق السور. وقد شيدت منازل عديدة حول المدرسة منذ القديم وحتى يومنا وتظهر عظام بشرية تحت أساساتها. وتضررت جميع أقسام هذه المدرسة بدورها من اجتياحات تيمورلنك. وكانت تزرع في باحتها أشجار تفوح منها روائح زكية وفيها بركة ماء لا تزال باقية حتى يومنا. وكانت للمدرسة أوقاف عديدة.
مدرسة شيدها شمس الدين لولو
مدرسة في مقام شيدها ابن أبي السيار المعروف ببهاء الدين
مدرسة في مقام شيدها عز الدين أبي الفتح مظفر في عام 1225م
المدارس الحنفية داخل السور
المدرسة الحلوية – هي أشهر مدارس حلب وكانت كاتدرائية مسيحيي حلب شيدتها الملكة هيلانة والدة الامبراطور البيزنطي قسطنطين. وعندما دخل الفرنجة إلى حلب في عام 1124م وهدموا وأحرقوا المقابر الإسلامية ردّ القاضي أبو الحسن بن الخشاب بأن حول هذه الكاتدرائية المشهورة إلى مدرسة(إلى جانب 3 كنائس أخرى-المترجم). وكانت المدرسة تدعى سابقاً “جامع السراجين” فحولها السلطان نور الدين إلى مدرسة وبنى فيها غرف عديدة لمدرسي الدين وبركة واسعة. وقد بدأت هذه الإنشاءات في عام 1250م. وعندما تم إنشاء البناء جلب نور الدين هيكلاً من الألاباستر نصف الشفاف من إحدى كنائس أفامية ووضعه في الجامع. ويقول بن الشداد: ((هي من أشهر المدارس وأكثرها استيعاباً لطلاب العلم ومؤمّنة بأحسن الواردات. وقد اشترط المؤسس بأن يقدم مبلغ 3000 درهماً للمدرس الرئيسي في شهر رمضان من كل سنة من واردات الأوقاف لمنحها للمدرسين بين العيدين لقاء الأدوية والفواكه والحلويات والأحذية. ومدرسة الحلوية هي الوحيدة في حلب اليوم التي تملك أوقافاً غنية تدر عليها مبالغ سنوية كبيرة. وبموجب إرادة سلطانية عثمانية فإن”أرض مشنا” الواقعة في منطقة العزيزية التابعة لكنيسة الأربعين شهيد الأرمنية تم تقسيمها وقدم نصفها للأرمن والنصف الأخر للمدرسة الحلوية.
المدرسة الشاذبختية – أسسها الأتابك والأمير الهندي جمال الدين الشاذبخت فقد كان أسيراً ويحكم حلب باسم نور الدين بعد إعتاقه. وبناء على أبي الدر كانت المدرسة تقع في سوق النشابين وتحتوي على محراب بديع وإيوان وغرف. وعندما انتهى بناء المدرسة استدعى المؤسس سلامة بن نجم الدين مسلم من سنجار مدرساً للدين. وبناء على أقوال ابن شحنة أيضاً كان هو ووالده من مدرسي هذه المدرسة بدعوة حاكم حلب الأمير سيف الدين.
المدرسة الأتابكية – أسسها شهاب الدين طوغرل الذي أعتقه الغازي وعينه حاكم القلعة وانتهى البناء في عام 1221م. وكان الإمام الشيخ جمال الدين خليفة من حوران المعلم الأول للمدرسة وخلفه مجد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين بن العديم الذي درس فيها حتى مغادرته لحلب. وقد أحرق المغول المدرسة لكن أعيد ترميمها ودرّس ولدا ابن الشحنة فيها. وكانت للمدرسة عقارات عديدة. ويؤكد أبو اليمن البتروني بأن المدرسة كانت قد زالت في عام 1625. ويؤكدون أيضاً بأنها كانت تقع على الجهة الشرقية من جامع العدلية.
المدرسة الحدّادية – شيدها حسام الدين محمد حفيد صلاح الدين وكانت إحدى الكنائس الأربع التي حولها القاضي ابن الخشاب إلى جامع. وقد قام تيمورلنك بهدم هذه المدرسة أيضاً إلى جانب مدارس أخرى إلى درجة استحالة استخدامها ثانية. ولكن عندما وصل الشيخ علاء الدين الجبرتي التقي الخيّر إلى حلب رمم المدرسة الصاحبية ثم طرد بعض النساء اللواتي قمن بالاستيلاء على مدرسة الحدادية والسكن فيها وقام بإعادة بنائها أيضاً. وقد وجد العمال في قعر البئر الذي كانوا يقومون بإصلاحه غطاء حجرياً لقبر مسيحي عليه صليبان يخص مقبرة الكنيسة التي تحولت إلى جامع- مدرسة الحدادية. اتخذت المدرسة تسميتها من ورشة حدادة كانت موجودة قرب هذا البئر.
المدرسة الجرداقية – أسسها الأمير عز الدين جورديق النوري عام 1200م في حي البلاط. وقد درّس المؤرخ ابن شحنة فترة في هذه المدرسة كمعلم لعلوم الدين.
المدرسة المقدّمية – أسسها عز الدين بن عبد الملك وكانت بدورها إحدى الكنائس الأربع التي حولها ابن الخشاب إلى جامع بعد استملاك وضم البيت بجانبها. رُممت في عام 1150م. وقد عين ابن العديم مدرساً دائماً لها حتى مقتله من قبل المغول. وكانت المدرسة تقع على شارع يدعى “درب الحطابين” الذي أعيد تسميته اليوم بشارع السلاّر. وقد شيدت مدرسة الشرفية لاحقاً انطلاقاً من مخطط ومسقط هذه المدرسة. وقد زال القسم الشمالي من مدرسة الجرداقية.
المدرسة الجوالية – كانت تقع في السهلية أي “سويقة حاتم” الحالية ببنائها الباسق وبابها المرتفع. أسسها عفيف الدين عبد الرحمن الجولي النوري.
المدرسة الطومانية – أسسها الأمير حسام الدين طومان النوري وكانت تقع على شارع الأصفري قرب حمام الهدباني وإلى جانبها مسجد.
المدرسة الحسامية – أسسها الأمير حسام الدين محمود بن خوتلو. ويؤكد ابن الشحنة بأنها تقع على الجهة الغربية من القلعة والشارع العام قرب الخندق. وهناك طريق على الجهة الجنوبية من المدرسة تؤدي إلى المدرسة العصرونية وجامع على الجهة الخلفية الشمالية. وكان من مدرسي الحقبة المغولية العالم شهاب الدين بن برهان ثم والده ثم المؤرخ وأولاده. وفي عام 1306 شيدت صومعة قرب المدرسة.
المدرسة الأسدية – معروفة ب”مدرسة الطواشي”. كانت تقع على الجهة المقابلة للقلعة. أسسها بدر الدين الذي كان أحد الأسرى الزنوج الذين أعتقهم السلطان أسد الدين شيراكوه. وبناء على أقوال أبي الدر كانت المدرسة تقع قرب باب منزل بني الشحنة على الجهة الداخلية للقنطرة. وقد جاء على مدخل المدرسة:((شيدت هذه المدرسة في عهد الملك العزيز من قبل العبد بدر الظاهري الأسدي في عام 1234)). وكانت المدرسة داره سابقاً. هدمت المدرسة في عام 1529 من قبل مفتش أوقاف حلب الملا محمد فزالت آثارها. وفي عام 1630 أقام خسرو باشا مجمعاً في المكان يحتوي على مسجد وجامع ومدرسة ودار للضيوف وكان هذا أول مجمع يبنى أثناء العهد العثماني.
المدرسة القلجية – أسسها الأمير مجاهد الدين محمد بن قلج النوري بن شمس الدين محمود وانتهى بناؤها في عام 1252م. وكان الشيخ مجد الدين أول مدرس فيها إلى جانب تدريسه في المدرسة الأسدية. زالت المدرسة منذ سنوات طويلة.
المدرسة الفُطيسية – أسسها الأمير سعد الدين مازوك وكانت داره قبلاً فتحولت إلى مدرسة في عام 1252م وكان محمد الفصيح أول معلم فيها. ويؤكد المؤرخ ابن الشحنة بأن المدرسة دمرت كاملة أثناء اجتياحات تيمورلنك وزالت آثارها إلى جانب مدارس عديدة أخرى. وكان عدد المدارس المخصصة للحنفيين فقط يصل إلى 40 مدرسة.
المدرسة المَجدية – شيدها مجد الدين بن الداية وكانت تقع داخل سور المدينة في حي البزة. هدمت المدرسة في عام 1530 ولم يبق منها أي أثر. أنشئت مدرسة أخرى خارج السور لاحقاً تحمل الاسم ذاته فزالت بدورها ولكن الموقع لا يزال يحمل اسم المدرسة.
المدارس الحنفية خارج السور
المدرسة الشاذبختية – بناء على تأكيدات أبي الدر(الجزء-4 ص 320)تقع المدرسةعلى الجهة الشمالية من حلب. أمر بهدمها حاكم القلعة باك في عهد الأشرف بارسباي واستخدمت أحجارها في بناء السور. وقد قدم عز الدين بن العديم عقاره للمدرسة بناء على فرمان ملكي. وكان شاذبخت قد منح المدرسة عقارات أخرى من أجل أعمال البر ولصومعة سونكورجا الصوفية بشكل خاص وصوفيي حران. وكان موفق الدين أبو الدانا محمد بن النحاس أول معلم في المدرسة بناء على رغبة المؤسس وكان يعمل في مدرسة أخرى أيضاً داخل المدينة. ويؤكد ابن الشحنة بأن المدرسة كانت قد زالت في أيامه وباع حاكم المدينة الوزير علم الدين ابن الجابي أحجارها.
المدرسة الآوشودية – أسسها الأمير التركماني عز الدين آوشود وزالت آثارها كاملة.
المدرسة السيفية – شيدها سيف الدين علي بن سليمان بن جندار. وبناء على أقوال أبي الدر تقع المدرسة خارج باب قنسرين في موقع المدفن العائد لبني أبي جرادة قرب خان السلطان وبجانبها جامع يحمل الاسم ذاته. وعندما بنى سيف الدين الجامع نقل القبور إلى جبل الجوشن.
المدرسة البولدوكية – تُركت هذه المدرسة دون عناية لفترة معينة بسبب بعدها وانزوائها لذلك هُدت مع الجامع القريب منها فاستخدمت أحجارهما أثناء ترميم سور القلعة.
مدرسة النقيب – شيدها الشريف والقاضي عز الدين أبي الفتوح المرتضى بن أحمد الإشاقي الحسيني على جبل الجوشن. وكان البناء مشهداً سابقاً حوّل إلى مدرسة وقام الشيخ بالتدريس فيها شخصياً في عام 1256م. ويؤكد أبو الدر بأن المدرسة تقع على قمة جبل الجوشن وكانت من الأماكن المفضلة لتنزه سكان حلب. وكانت التلة تسمى “تاج حلب” لوجود قصر المعز الذي يحتوي على غرف عديدة ومسجد جميل جداً. ومؤسس المدرسة مدفون قرب المسجد.
المدرسة الدقاقية – أسسها فضل الله بن الدقاق بن مهذب الدين أبي الحسن العلي في عام 1264م وكانت تقع شمالي الفيض حسب رواية ابن الدر وتعمل حتى عهد الملك الناصر ولكن لم يبق منها أي أثر في أيام ابن الشحنة لأن حي الفيض كان قد هد بالكامل. ومن المحتمل جداً بأن الجامع نصف الخرب والتربة الواقعة إلى جانبه على مرتفع الفيض شيدا في موقع هذه المدرسة.
المدرسة الجمالية – أسسها جمال الدولة إقبال الظاهري وتقع حسب ابن الدر على الجهة الجنوبية من المدينة خارج باب المقام وإلى جانبها بئر. ويذكر أيضاً بأن المدرسة كانت جميلة جداً وواسعة واستخدمت أحجارها لبناء منشآت أخرى لاحقاً.
المدرسة العلائية – أسسها علاء الدين بن أبي الرجاء رئيس ديوان السلطانة ضيفة خاتون بنة الملك العادل. لم يبق من هذه المدرسة أي أثر في وقت ابن شحنة.
المدرسة الكمالية-العديمية – تقع على الجهة الشرقية من حلب. شيدها الوزير كمال الدين عمر المعروف بابن العديم ثم ابتنى قربها مدفناً وحديقة. وقد دام تشييد المدرسة عشر سنوات حتى عام 1252م.
المدرسة الأتابكية – شيدها الأتابك شهاب الدين طوغرل الظاهري الذي جاء ذكره في الأعلى وانتهى بناؤها في عام 1224م.
يكتفي ابن الشداد بتعديد المدارس الحنفية والشافعية فقط. وإلى جانب تلك المدارس هناك المدارس التالية التي تخص المالكيين والحنبليين:مدرسة تحت القلعة أسسها جاندار بن علم الدين سليمان بن أمير سيف الدين علي وخُصصت للطريقتين الحنبلية والمالكية. ويذكر ابن الشحنة بأن المدرسة كانت منسية والباب مسدوداً بالحجر لا يعلم ماذا حل بها بعد مغادرته لمدينة حلب. وكانت هناك زاوية ومدرسة داخل السور في الجامع الكبير. وقد شيدت المدرسة من قبل القاضي بهاء الدين بن الشداد ومدارس أخرى بنيت من قبل مجد الدين بن داية وبدر الدين الأسدي والملك الصالح إسماعيل. أما المدارس الواقعة خارج السور فهي:زاوية في الفردوس ومدرسة بناها الوزير مؤيد الدين إبراهيم التي كانت تسمى “البدرية” في الماضي. وقد دُرست في جميع هذه المدارس مبادئ الدين من وجهة نظر هذه الطرق وانطلاقاً من مفاهيم العصر. وكما نرى كانت فترة القرنين 13م و14م حقبة ازدهار هذه المدارس إلا أن ضربة مدمرة سُددت لها بسبب اجتياحات تيمورلنك فزالت مع مخطوطاتها الثمينة ولم يبق منها سوى القليل جداً.
- Sauvaget (Les Perles Choisies d’Ibn ach-Chihna) I, Beyrouth-1933,p. 108
الفصل الحادي عشر
المدارس المؤسسة بعد المؤرخ بن الشداد
المدرسة الكلتاوية – تقع داخل باب القناة. أسسها الأمير توكتامور الكلتاوي وبجانبها قصر منيف غطى سطحه الخارجي بالمرمر. وكانت اسطبلات واسعة عديدة تقع على الطابق الأرضي وحوانيت على الجهة الأمامية. وهذه الأبنية ومنشآت أخرى كانت مخصصة للمدرسة كوقف واشترط المؤسس أن ينتمي المعلمون وجميع الطلاب إلى المدرسة الحنفية.
المدرسة الإلجائية – كانت قريبة من جامع سيف الدين جعفر وتقع خلف باب المقام وعلى الجهة اليسرى من الشارع العريض القريب.
المدرسة الكنوغية – تقع داخل باب النيرب ويقال بأنها كانت زاوية في الوقت ذاته, حقيقة لا يمكن تأكيدها.
المدرسة الناصرية – كانت المدرسة كنيساً يهودياً سابقاً يدعى ميدخال.
المدرسة الشهابية – تقع على الجهة المقابلة لمدرسة الناصرية وهي من المدارس الحنفية في حلب.
المدرسة الكاملية – بناها ابن كامل وتقع قرب المدرستين السابقتين.
المدرسة الصاحبية – تقع على الجهة الشمالية من المدرسة الجرداقية.
مدرسة لا يعرف اسمها كانت تقع على الجهة الغربية من حارة اليهود.
المدرسة الياشباكية- كانت تقع بجانب سبيل سوق النشابين. شيدها الأمير ياشباك اليوسفي المؤيد حاكم حلب وبعد مقتله في عام 1421م وري في مدفنه داخل المدرسة. وقد خصص الأمير السوق القريبة من المدرسة وقفاً لها. ويؤكد أبو الدر:((هذه المنشأة مؤلفة من مدفن ومسجد ومدرسة للأيتام أسسها ياشباق قرب الصهريج الذي شيده ألتونبوغا وعين للمدرسة معلماً حسب السنن النبوية في 21 كانون الثاني عام 1420 وخصص عقاراً هو عبارة عن سوق. وقد أوقف للمدرسة أيضاً الحديقة التي يسكن فيها حاكم حلب إلى جانب أوقاف أخرى)).
المدرسة التغري- فيرميشية – بناها حاكم حلب تغري-فيرميش تحت القلعة وكان ابن أحد التجار. وكانت زاوية الحاكم تقع حسب تأكيد أبي الدر(الجزء-3 ص 41) قرب جامع دامورطاش حيث كان سوق الخيل ولم يكن هناك بناء آخر. وقد اشترى الحاكم السوق بمال الدولة وأسس المدرسة في عام 1437 وانتهى من البناء في السنة التالية ثم خصص بعض العقارات حول المدرسة والأراضي في القرى أوقافاً لها واشترط على تعيين شيخ أعزب ليدرس على الطريقة الحنفية. وقد شيد الحاكم مدرسة أخرى للأيتام على هذه الزاوية ووضع فيها مدفنه. وفي أحد الأيام عندما عاد إلى المدرسة سمع بأنهم يقرأون القرآن. وعندما سأل عن السبب أجابوه بأن الطلاب يقرأون على روح مؤسس المدرسة. والزاوية جميلة ومبنية بأحجار كبيرة وأرضيتها مرصوفة بالمرمر الأصفر وغيره من الألوان. وكانت مراحيض ومطبخ الصوفيين تقع إلى جانب الزاوية. وقد رغب المؤسس بوضع هذه الأوقاف تحت رعاية حاكم قلعة حلب ولكنه خشي من هدم الزاوية من قبل العصاة في القلعة بعد وفاة الملك الأشرف فأسند مهمة السهر عليها إلى مراقب البناء الرئيس ضياء الدين بن النصيبيني)).
المدرسة السفاحية – شيدها القاضي شهاب الدين للشافعيين وأشار أيضاً بإمكانية دخول الحنفيين إليها للصلاة فقط. وبعد وفاته عين مدرس شافعي هو القاضي الأكبر للحنفيين الشيخ شرف الدين أبي بكر. يقول أبو الدر(الجزء-4 ص 191):((شيدت مدرسة وجامع من قبل سعادة أبي العباس أحمد ولم يكن في الجامع منبر. . . وقد بنيت المدرسة على موقع معصرة سمسم فقام المؤسس بنقلها على الجهة المقابلة للمدرسة. وعندما بُديء بحفر الأساسات اندفعت مياه جوفية قوية بحيث لم يتمكن العمال من إيقافها فاحتاج الأمر إلى وضع أطباق من خشب التوت لرفع الأساسات. وكان المهندس يدعى مصطفى فاستبدلوه بآخر يدعى محمد شُقير. وقد جلب الحجّار المصري الذي يدعى محمد الفيل أحجار مرمر صفراء وسوداء ونقل باباً موجوداً أمام المدرسة الزجاجية وخصصه للمدرسة. وقد تعرض الحجار لهجمات خطيرة من قبل ابن رزاز الحنبلي أثناء رفع أحجار البناء وخاصة عند وضع أحجار زوايا الأساس. ولكن الله تعالى أعلم بأعمال الناس الصالحة والشريرة. وكان محراب المدرسة والجدار الجنوبي مبنيان بأحجار المرمر الأصفر والأسود وكانت الأبواب آيات فنية في النجارة وجميعها صنعت من قبل الحاج أحمد بن الفقيه تحت إشراف النجار الحاج عبد الله. وهناك نافذة واحدة قرب قبر ابن مؤسس المدرسة صنعت من قبل نجار غريب كان يسكن في حلب. وقد استخدم القاضي شهاب الدين هذا الغريب لصنع الشباك وقفصه الحديدي. وقد تم رصف أرضية باحة المدرسة بأنواع المرامر الجميلة الفريدة. وهذا القاضي بالذات هو الذي خصص جميع أملاكه وقفاً للجامع من عقارات وكتب قيمة وأمر أيضاً بتنظيف الحي يومياً. وقد وظف أيضاً إماماً وسبع مدرسين لتنظيم التعليم والصلوات اليومية الخمس. وقد بدأ البناء عام 1418 وانتهى في سنة 1421.
مدرسة أكجا – كانت تقع في حي السفاحية بناها أكجا خزنادار مملوك ياشباق اليوسف. وكان للمدرسة بابان الواحد منهما أمام مدرسة السفاحية والآخر على الطرف الخلفي. وكان للمدرسة خزان ماء. وقد حلت على بنائي هذه المدرسة اللعنة لأنهم رفعوا البناء دون أساسات. وقد شيد أكجا أيضاً زاوية قرب سبيل في شارع الحدادية ولم يتمكن من إنهائها وحولها في النهاية إلى منزل يسكن فيه. وعندما حاصر الملك الأشرف آمد فكر في حيلة لتسهيل الحصار فطلب من أكجا ببناء سد يطل على المدينة. وعندما وجد الملك بأن ما شيد لا يتطابق مع ما أمر بتنفيذه قال له: لم يكن هذا ما طلب منك تشييده. فرد عليه أكجا قائلاً:عيّنك الله ملكاً لا مهندساً. وقد رغب السلطان بقطع رأسه لكنه تمكن من اللجوء إلى إيران ثم إلى مكة وعاد إلى حلب فقط عندما سمع بوفاة الملك الأشرف.
المدرسة الدولقارية – بناها الأمير نظير الدين باك محمد بن دولقار قرب خندق السور الخارجي الشمالي للمدينة لصالح المسلمين الحنفيين وعين الإمام شهاب الدين أحمد الشيخ بن موسى المرعشي مدرساً لها. وقد اشترى خلفاء الإمام المدرسة وقاموا بتحويلها إلى مدرسة شرعية دينية. وقد شيد نظير الدين مدرسة أخرى للحنفيين في حلب على خندق باب النصر. J. Sauvaget (Les Perles Choisies d’Ibn ach-Chihna) I, Beyrouth-1933, p. 170
ينفرد “ملحق أزتاك العربي للشؤون الأرمنية” بنشر صفحات كتاب “تاريخ حلب “للأسقف أردافازت سورميان.
* من كتاب “تاريخ حلب” للأسقف أردافازت سورميان، مطران الأرمن الأسبق في حلب، (1925 – 1940)، ترجمه عن الأرمنية الدكتور ألكسندر كشيشيان، عضو اتحاد الكتاب العرب وجمعية العاديات، حلب، 2006.