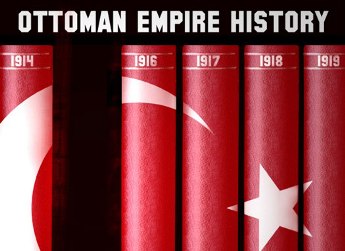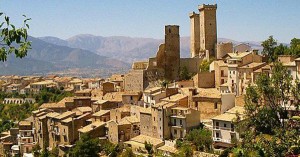![March (hi-rez)]()
رستم محمود
التقيتُ يغمور دميرباش في مدينة بدليس ذات الأغلبية السُكانية الكردية في أقصى جنوب شرق تركيا. بمظهره العام وسلوكياته الحركية، وحتى بطريقة توزيعه لنظراته وبسماته على ضيوف الفندق «الغرباء» أمثالي، يبدو يغمور شخصاً كُردياً تقليدياً.
الرجل السبعيني «المربوع»، ذو الوجنتين الحمراوتين والشعر الأشعث الكثيف، بادرني بالسؤال إن كُنت قادماً لحضور مؤتمر «تحولات المُدن الكردية في ربع القرن الأخير» بكردية رصينة، وحين أخبرته بصحة توقُعِه مع شيء غير قليل من الحذر، رصّ على أسنانه وقال بصوت غير مسموع تقريباً «لقد ألغوا المؤتمر». استغربتُ وسألتُ عن الجهة التي فعلت ذلك، طالما أن الأمر برعاية رسمية من بلدية المدينة، وسيُعقد في صالة عامة وبشكل علني.
حين تأكد الرجلُ من «جهلي» العميق ببواطن الأحوال في المدينة والإقليم كله، أطفأ الراديو الصغير على مكتبه الخشبي، ووقف مترنحاً، مدّ يده اليُسرى في إشارة لطلب المرافقة إلى مكانٍ ما.
صعدتُ وإياه إلى جناحه الخاص في الفندق الذي يملكُه.
بعد دقائق من أسئلته الكثيرة عن هويتي ومهنتي وجهة قدومي، واكتشافه السريع لعدم ارتياحي لتلك الطريقة في «الاستجواب»، باتَ يغريني أن أسأل أنا عنه، وما أن طرحتُ عليه السؤال الأول، حتى سردَ كل سيرة عائلته، وهذا نصها بكثير من الأمانة.
***
في صيف عام 1915 كان اليافع الأرمني كيفورك يّركاد يعيش في اسطنبول، طالباً في المدرسة الطبيّة العثمانية، التي كان قد أسسها السلطان محمود الثاني قبل قُرابة نصف قرن. وما كان له أن يدخل تلك المدرسة النُخبوية العثمانية لولا علاقة والده مع تاجرٍ يهودي اسطنبولي، فعائلة يّركاد كانت تنحدر من بلدة صغيرة جنوب شرق مدينة ريزى على البحر الأسود، وكانت تتاجر بالبندق مع هذا التاجر اليهودي، الذي كان يُصدِّره من اسطنبول إلى أغلب المُدن الإيطالية.
من المشفى الطبي/العسكري التابع للمدرسة الطبية العثمانية، كان كيفورك يستطيع الاطلاع إلى حدٍّ معقول على مجريات الاحداث في شرق البلاد آن ذاك. فنزعة الكراهية الممزوجة بكثيرٍ من الأخبار حول الأعمال العسكرية التي كانت تجري في أقصى شرق الامبراطورية بحق الأرمن كانت تتوارد بكثافة، تلك التي بدأت منذ نيسان ذلك العام. وإذا لم تكن أحداثٌ مشابهة منتشرةً في العاصمة اسطنبول، فإن كثيراً من القادمين الأرمن من مختلف أنحاء الامبراطورية كانوا يُخبرون ذويهم في إسطنبول بمجريات ما كان يحدث، من حملات تهجير واقتلاع وعنف بحق سُكان البلدات والقُرى الأرمنية.
كان كيفورك من الذين انقطعت صلاتهم مع ذويهم منذ نهاية شهر أيار، ولم يلتقِ بأي قادم جديد من تخوم ريزى في المقهى الاسطنبولي الشهير الذي كان مقصدهم على الدوام. هو نفسه بات يخشى الذهاب إلى ذلك المكان بشكل دائم، بعدما حذره أصدقاء مقربون من الكشف الواضح عن هويته الأرمنية. ولم يكن البريد يحمل له أي رسالة خاصة توضح له شيئاً مما يجري هناك.
لم يكن لكيفورك من قريبٍ يثق به سوى التاجر اليهودي صديق والده، هذا الأخير نفى له أي علم بما يجري في تلك المنطقة، وأوصاه بأن يختفي عن الأنظار، فشبان المدارس العلمية العثمانية هم الأكثر نشاطاً ومشاركةً في حملات الكراهية في اسطنبول.
فعل ذلك بحزم، لكنه عاد بعد أسبوع للتاجر اليهودي وطلب منه مساعدته للعودة لبلدته. أكد له اليهودي بأن الأمر بمنتهى الصعوبة، وأن أياً من التجار المحليين لم يوافقوا على مرافقته لهم إلى هناك، حتى السُفن التي تُبحر من اسطنبول إلى ميناء ترابظون لن تقبل به، وأن سفره عبر الرحلات التقليدية خطرٌ للغاية. لكنه عرض عليه بالمقابل مرافقة رجال دين يهود من معارفه، الذين يستطيعون إيصاله إلى مدينة أضنة، وعليه أن يتدبر أمره من هناك إلى بلدته.
بقي كيفورك قرابة أسبوعين في منزل التاجر اليهودي/الإسطنبولي، تعلّم خلالها بعض الترانيم الدينية اليهودية، كي لا تُكشف هويته الدينية والقومية فيما لو تعرضت قافلة رجال الدين اليهود للمسائلة الأمنية في طريقها الطويل نحو أضنة.
حينما وصل كيفورك مدينة أضنة، هاله حال الأرمن في المدينة، الذين لم يكن قد بقي أي منهم تقريباً، ساعده متعهد إطعام كُردي على التخفي بهيئة عطار كُردي، وهو الذي لم يكن يعرف عبارة كُردية واحدة، سوى ما تعلمه من أرقام وأسماء لبضاعته القليلة.
سار كيفورك لأكثر من خمسة عشر يوماً في الدروب التي كانت تصل أضنة بشرق الإمبراطورية، وبعد أن غادرَ مدينة أورفا بيوم واحد صادف قافلةً من قُطاع الطريق، الذين كانوا ينهبون القوافل، ومنها قوافل المهجَّرين الأرمن. اقترب كيفورك من القافلة كي لا يوحي بأنه يُخفي شيئاً ما، وحين كلمه بعضهم بالكردية واكتشفوا جهله البالغ بها، وتحت الضغوط، اعترف بهويته وحقيقة أمره، خصوصاً أنهم هددوه بالكشف عن «عورته» لمعرفة أصله لو لم يعترف. كاد الاعتراف أن يُنهي حياته، لكن أعضاء القافلة طلبوا منه مداوة إبن كبيرهم الذي سقط من على ظهر الفرس في الليلة الفائتة، وكُسرت قدمه اليُسرى. اعتنى كيفورك بالمراهق، وسهر على مداواته لأسبوعٍ كامل.
بعد أسبوع وصلت القافلة إلى قرية جلبي آغا، وهي كانت تقع -حسب مروية كيفورك- في منطقة وسطى بين مُدن ماردين وديار بكر وباطمان. اطمأن إلى حاله في بيت هذا «الزعيم» العشائري، الذي ارتاح له بدوره لأنه أنقذ ابنه من موت مُحتم.
خلال أيام قليلة هناك، أدرك كيفورك حقيقة الفظائع التي جرت في إقليم بلدته الأرمنية، وكلما كان يريد أن يُغادر، كان جلبي آغا يمنعه من ذلك بدافع الحفاظ عليه، طالباً منه الانتظار حتى أوائل الربيع، ليستطيع مرافقة البدو الكُرد نحو سهول الشمال الشرقي من البلاد.
خلال الشهور الستة التي فصلت بين وقت وصوله وبين موعد مغادرة قوافل البدو الكُرد الذين كانوا يجتمعون في قرية جلبي آغا، كان أمران قد طرآ على يوميات كيفورك، وغيرا من حياته وهويته تماماً.
تعلم كيفورك الكردية إلى حد معقول، وبات يستطيع عبرها تنظيم جميع شؤون حياته مع هؤلاء «الغُرباء»، فقد طلب منه هذا الزعيم إدارة دفاتر حساباته الزراعية، فأرضه كانت تمتد على مساحة عشرات القرى، ولم يكن أي من أبناءه أو أخوته يعرف القراءة والكتابة بالتركية، وبات ذلك مع بعض أعمال التطبيب البسيطة لسكان القرية والقُرى المجاورة يُحرز له دخلاً يتجاوز ما كان يحلم به على أي حال.
من جهة أخرى كانت النظرات والبسمات تزداد بينه وبين ناريمان زلفو، ابنة أخت جلبي آغا من زواجها الأول، ولحظه العاثر -وربما السعيد- فإن أول محاولة منه لمسك يديها حين كانت تأتي له بالفطور كل صباح، وهي بكامل أناقتها والكحل الذي يفيض من عيونها، قد التُقطت من جلبي آغا نفسه، حينما دخل فجأة ورآه بعينيه يفعل ذلك. وقتها سقطت «سُفرة» الإفطار من يد اليافعة ناريمان زلفو وهمّت بالاختباء من نظرات خالها القاسي، وهرولت إلى قسم الحريم. حين حاول كيفورك فعل ذلك، نهره جلبي آغا قائلاً «عيب الزُلم يهربوا يا أبني». كانت الكلمة الأخيرة قد أدخلت شيئاً من الطمأنينة إلى قلب كيفورك.
ما أن صلّى جلبي ظهر ذلك اليوم، حتى أمسك يد كيفورك وسار به إلى بيت عبدالله رشكاني، زوج أم ناريمان زلفو، ثم أرسل في طلب بعض رجال القرية. حين أكتمل الحضور، توجه جلبي آغا لعبدالله رشكاني طالباً يد ناريمان لكيفورك، وحين تنحنح «ملا القرية»، رد عليه جلبي آغا وهو يوجه نظراته لكيفورك قائلاً «مُسلم سيدا مُسلم». حيث أخفض كيفورك رأسه حينما تلقى كلمات جلبي آغا تلك، وباتَ اسمه منذ ذلك اليوم «كامران يّركاد».
***
عاشَ أبي كيفورك يّركاد/كامران دميرباش كل حياته الباقية كُردياً بين الأكراد، لكنه كان في لحظات خلوته يدندن الأغاني الأرمنية، ويسرد حكاياتهم وأساطيرهم ومخيلاتهم وأوجاعهم على ذويه وصحبه ورفقة حياته. وفي لحظاتٍ غير قليلة، كنا نلتقط دمعته المنهمرة، في لحظات كنا نظنها عادية للغاية، كأن يتحدث أحدهم عن أمه لحظة وفاتها.
لم يجرب أبي العودة إلى ديارهم التي كانت، بعدما سمع وتأكد بأن أحداً من ذويه لم يبقَ هناك. مرة واحدة جرب السؤال عنهم، وسافر إلى مدينة حلب السورية في أواسط الأربعينات، لكنه عاد بدون أي شيء، فقد أخبره الأرمن هناك بأنهم شاهدوا فقط واحداً من أخوته، وأنه غادر حلب إلى الولايات المتحدة بعد شهرين فقط من إقامته فيها.
كان أبي يحلم بالحفاظ على الشيء الوحيد من أرمنيته، اسم عائلته. لكن حين قررت السلطات التركية في أربعينات القرن المنصرم «تتريك» جميع أسماء العائلات، تخلى عن تسمية «يّركاد» واختار كلمة «دمير»، فكلاهما تعني «حديد». أخبرتنا أمي بعد رحيله بأيام قليلة، بأنه في ذلك اليوم فقط، يوم إجبار والدي على تغيير اسم عائلته، لم ينم أبي في المنزل، نام في البراري.
***
ولدتُ لأبوي بعد خمس بنات، كانت أمي تسميني «وحيد اليتيمين»، وأسماني والدي «يغمور». فحسب ذاكرته القديمة، كانت ليلة ماطرة يوم غادر بيت والده لآخر مرة، و«يغمور» تعني المطر.
لم أرَ «جلبي آغا» أو أياً من ذوي أمي قط، فبعد سنوات قليلة من زواج أبي، ساءت العلاقة للغاية بينه وبين أهل أمي. لم يكن أبي شخصاً ملتزماً دينياً، وأتهمه بعضٌ منهم بأنه لم يُسلم من قلبه، وأن الكُتب الأرمنية والتركية التي في بيته إنما تُحرض على الكُفر بالله، خصوصاً وأن الشك بات يلاحق أبي كـ«شيوعي» منذ أوائل الثلاثينات.
هاجر أبي إلى مدينة ديار بكر، وهناك ولدتُ عام 1941، بالقرب من سور المدينة القديم، وكان والدي يقول لي مبتسماً «هذا السور بناه جدُك الملك الأرمني ديكران العظيم». كنت طفلاً ولا أعي ما يقوله والدي.
لكن السور نفسه تحول إلى مكان غطى كل أيام يفاعتي وصباي، فعشتُ كطفل كُردي عادي، إبناً لمالك حانوت وسط المدينة، شيوعي الهوى والانتماء، وأم كُردية أميّة تماماً، تدور في بيتها اجتماعات نساء الحارة كلهن، صباحاً وظهراً ومساءاً، حتى أن زوجها كان يقول لها مازحاً «لو كان في جامع للنساء، لكنتِ ملا الجامع»، فأمي بالإضافة لدماثتها الاجتماعية الفائضة، كانت تُكثر من العبادات الدينية، فدرجة حُبها لزوجها «الشيوعي» كانت تدفعها لأن تُكثر من تلك الفروض، علَّ الله يتقبّل ذلك عنها وعن زوجها «حبيبها».
***
في المدرسة هالَني بالتقادم حجم القهر، فقد كان ممنوعاً علينا التكلم بالكُردية، أو حتى التعبير عن انتماءنا القومي باللغة التركية، وكان واجباً علينا كل صباح التصريح بسعادتنا لانتمائنا للأرومة القومية التركية، والتعبير الدائم عن الولاء للزعيم مصطفى كمال أتاتورك.
عشتُ سنواتٍ كثيرة من عمري في الحيّزين المتناقضين، ففي المدرسة كنتُ أتلقى -كجميع الأطفال- ضخاً كثيفاً من الدعاية والإيديولوجيا القومية التركية بنمطها الأتاتوركي، الذي يُفسر العالم والتاريخ والحاضر والمستقبل بالسردية القومية التركية، وينكر أي حضورٍ وقيمةٍ ومعنى لأي قومية أو جماعة أخرى، وبالذات الكُرد منهم، حيث لم تكن تعترف الأعراف المدرسية بوجودهم أصلاً، رغم أن الأغلبية المطلقة من الطلبة كانوا كُرداً، ولم يكونوا يعرفون، هُم وذووّهم، النطق بكلمة تركية واحدة حينما كانوا يأتون للتسجيل في المدرسة.
على وجهٍ نقيضٍ لذلك تماماً، كانت حياتي المنزلية والاجتماعية على النحو الآتي: أمي كانت كُردية تقليدية للغاية، لا تعرف كلمة تركية واحدة، تمضي وقتها في الأعمال المنزلية نهاراً، وسرد «الخرافات» الكردية الجبلية الجميلة علينا، وعلى نساء وصبية الجيران ليلاً. كانت أخواتي البنات يتمنينَ أن تكون الحكايات عن الحُب والغرام كل مساء، وكنت أصرُّ أن تكون حكايةً عن المعارك والفرسان والبطولات.
إلى جانب ذلك، كان أبي شيوعياً وقارئاً نهما، يقرأ حتى الجريدة التي تضعها أُمي على طاولة الطعام، رافضاً و«مقاوماً» النزعة الإيديولوجية الرسمية للدولة، مازجاً بين حسٍّ أخلاقي شيوعي مكين، ونزعة قومية كُردية، ترفض هذا القدر من «إهدار» الحق. ومع صبية كُرد كانوا بأغلبيتهم من المنحدرين الحديثين من القرى الكُردية المُحيطة بمدينة ديار بكر. كانوا يعيشون أنماطاً من الحرمان والقسوة التي لا توصف، فأفراد عائلاتهم كانوا غرقى بأنماط من الحياة التقليدية، حيث العشائرية والتبعية لشيوخ الطرق الصوفية، يمنعون الإناث من دخول المدارس، ولا يُكمل الذكور منهم السنوات الأولى من الدراسة، فقط لأن ذويهم لم يكونوا يعرفون التركية، ولا يستطيعون الاهتمام بأطفالهم، ولأنهم كانوا يفضلون عمل أطفالهم في «السُخرة» المدينية، ليستطيعوا توفير قوت العائلة اليومي.
خلال سنوات الدراسة في ديار بكر، تعمّق ارتباطي باللغة والعوالم والمخيلة والمنطق التركي، وتهمَّشت بالتقادم ذاكرتي الكُردية. فقد كنت أقرأ كل العلوم باللغة التركية، ممتثلاً لهواية والدي الرصينة، فالقراءة كانت متعتي الأكبر، وربما الوحيدة. عن طريقها تعرَّفت على أشعار ناظم حكمت، وحكايات يشار كمال، التي كانت تتطابق مع حكايات أمي. عبرها فقط درست تاريخ تُركيا السياسي والاجتماعي، وتلقفت الإيديولوجيا الشيوعية، التي لم تَرُق لي بقدر ما كانت تروق لأبي، حيث وجدت فيها على الدوام ما يخلُّ بالحقوق القومية للأكراد في تركيا، ووجدت أن الحركة القومية/اليسارية الكردية هي الأقرب إلى حسِّ العدالة.
كان عام 1960 عاماً استثنائياً بالنسبة لي، ففي شتائه الأول قُتل أبي عن طريق الخطأ وهو يحاول الفصل بين مراهقين متخاصمين في سوق المدينة، وبُعيد مغادرتي ديار بكر باتجاه إسطنبول لدراسة الهندسة المدينة في جامعة أتاتورك بقرابة شهرٍ واحد حدث انقلاب إلب أرسلان، وما أن مرَّت شهورٌ قليلة من التخفي الذي أجبِرتُ عليه لانتمائي لإحدى التنظيمات الطلابية اليسارية، حتى أتاني خبر وفاة والدتي بمرض «ذات الرئة»، وهربت أختي الصغرى مع شاب قروي كان ذووّه قد نزحوا قبل سنوات قليلة إلى حيّنا في ديار بكر. لم أستطع حضور جنازة أمي ولا عزاءها الذي أقامه بعض أصدقاء أبي والجيران، وكذلك لم ألتقِ بأختي الصغرى بعد ذلك قط.
عملياً انقطعت علاقتي بديار بكر تماماً، فأختاي الكبيرتان كانتا قد هاجرتا مع زوجيهما إلى ألمانيا قبل عدة أعوام؛ والثالثة توفيت وهي في الخامسة عشرة من عمرها؛ الرابعة كانت تسكن مع زوجها في مدينة أضنة؛ والصغيرة غادرت مع الشاب القروي، ولم نعد نعرف عنها أي شيء. حتى أخواتي البنات لم يعد من صلة بيني وبينهن، فلم أكن أملك عنواناً بريدياً بعد التخفي، وكنت أخشى الاتصال بهن، فالدعاية العسكرية كانت توحي بأن كل هواتف البلاد مراقبة بشكل صارم.
كان عاماً أليماً للغاية، عشت شهوره الست الأخيرة في منزل لأحد الرفاق الذين كانوا معي في المنظمة اليسارية. إلى أن أتى هذا الرفيق يوماً ومعه هوية شخصية لأحد أقاربه، وقال لي إنه يمكنني الخروج بهذه الهوية الشخصية بل والعيش بها مدى الحياة، لأن رفيقي كان قد اتفق مع والد المتوفى على عدم تسجيل حالة وفاة ابنه في الأوراق الرسمية.
***
عشت باسم «دنيز ظافر جانكير» لشهور قليلة، لكن كنت أودّ العودة للدراسة الجامعية بأي شكل، وقتها نصحني قريب دنيز بأن أتقدم لامتحان الشهادة الثانوية من جديد باسم «دنيز ظافر جانكير»، لكن الأمر كان يحتاج للحصول على شهادة تعريف من مختار القرية التي ينحدر من دنيز بالأساس. سافرت إلى قريتهم التي كانت بالقرب من مدينة بورصة في ربيع عام 1961، ولم يكن والد دنيز يستطيع أن يصرح بذلك لمختار القرية بشكل مباشر، فالمختار كان عضواً نشطاً في الحركة اليمينية القومية التركية، وكان والد دنيز شيوعياً.
طلب مني الإقامة في منزلهم لعدة أيام حتى يستطيع إيجاد حل للمسألة، خلال تلك الأيام حدثت علاقة غريبة بيني وبين والدة دنيز، الأم التي كان يغالبها حسّ الأمومة، وباتت تتخيلني ابنها الذي افتُقِدَ في ليلة ظلماء. بدوري لم أكن أقلَّ تواطؤاً وموافقةً على ذلك الأمر، أنا الذي كنت محروماً من أيّ عائلة أو أقرباء، ولم أكن قد بلغت العشرين من عمري بعد.
قبل حصول والد دنيز على شهادة التعريف من المختار بأيام قليلة، تعرفت على «شمس ظافر جانكير» أخت دنيز التي كانت تصغره بعام واحد، وتكبرني بعام. تبادلنا عناويننا في اسطنبول، والكثير من النظرات والأحاسيس غير المفهومة آنذاك.
لم يمضِ شهرٌ واحد حتى طرقت شمس باب بيتي في حيّ «قاسم باشا» الاسطنبولي، طلبتُ منها البقاء حتى الصباح، لأن الوضع الأمني غير مناسب للعودة في المساء. ارتضت بالبقاء دون نقاش، وبقينا في البيت نفسه لسنوات كثيرة، وبقينا سوية لأكثر من أربعين عاماً، الأربعة الأولى منها كأخوين أمام الجيران، وصديقين بحضور الأصدقاء، وحبيبين فيما بيننا، وكزوجين بعد حدوث العفو العام من السلطات الانقلابية، وعودتي لاسمي الأول «يغمور كامران دميرباش».
عشتُ طوال سنواتي الأخرى كمواطنٍ تركي اسطنبولي، أمتهنُ الهندسة المدنية التي كانت تتلقى طلبات كثيرة للعمل، فاسطنبول توسّعت عشرات المرات في ذلك العقد، وتزايد عدد ساكنها لأكثر من خمسة أضعاف. في العمق كنت يسارياً ومواظباً على النشاط السياسي في تنظيم الحركة الماوية الشيوعية، وفي عمقٍ أكبر طفلاً كردياً بعيداً عن كثيرٍ من طفولته وكُرديته البسيطة.
***
دخلتُ تلك الحياة الرتيبة والمستقرة، ذلك الشيء الذي كنت أحتاجه منذ سنوات كثيرة، وبات لي طفلان جميلان، مشكلتي الوحيدة معهما أنهما لا يفهمان الكُردية قط، ولا أستطيعُ أن أوصل لهما أياً من حكايات أمي الشيّقة. وزوجةٌ جميلة ومُحبة، تُتقن كل فنون الحياة الطيبة، ومنها بالذات دندنة أغاني زكي مورن التركية العظيمة.
في ربيع عام 1971 تغير كل شيء في حياتنا، فعاد الانقلاب العسكري بطريقة أكثر وحشية، وبات يهدد كل من يحمل رائحةً يسارية/شيوعية. وقتها لم يكن أمامنا سوى الفرار السريع، غادرنا بمساعدة بعض الأصدقاء إلى سوريا، وهناك على التخوم السهلية بين أورفا وديار بكر كنت أتذكر كل حكاية أبي وعذاباته، أيام الطفولة والصبا في ديار بكر. من هناك غادرنا إلى ألمانيا الشرقية، ومنها إلى مدينة فرانكفورت الألمانية الغربية، حيث كانت تعيش أختي الكبرى منذ عشرات السنوات، مع زوجها وعائلتها، التقينا بعد فُراق دام أكثر من خمسة عشر عاماً.
***
بعد أقل من شهرين من وصولي لألمانيا اندمجتُ في الحياة العملية، وبتُّ مهندساً مشرفاً في شركة زوج أختي، حيث كان كل عُماله من المهاجرين الأتراك، ولذلك السبب بالذات لم أتقن الألمانية بأي شكل، ومن هنا انبعثت مأساتي الثالثة في الحياة.
بينما كان تفاعلي وانشغالي مع عُمالٍ وموظفين أتراك تقليديين، كانَ ولداي ينسيان التركية بالتقادم، وباتت اللغة والثقافة الألمانية تشكّلان أداتهما في الفهم والوعي والتعبير. لم يكن الأمر يتعلق باللغة والثقافة فحسب، بل بنمط الحياة ورؤية العالم والظواهر والسلوكيات.
قبل عشرة أعوام توفيت زوجتي شمس ظافر جانكير بسرطان الدم، وقررتُ بحزمٍ أن أدفنها في ديار بكر وليس في أي مكان آخر. تأخر قدوم ولديَّ أربعة أيام حتى ألتحقا بي في المدينة، ولم تكن بيننا أيُّ لغةٍ مُشتركة، بالذات الأشياء التي تتعلق بالحياة الوجدانية العميقة، كالمواساة والعزاء والفرح وكل الأشياء العميقة.
***
يعيشُ ابني كيفورك الآن في الولايات المتحدة متزوجاً من برازيلية سوداء، ويمتهن تجارة السيارات، يتقن الألمانية لغةً وثقافةً وحياة، بينما لا يتقن أولاده «أحفادي» سوى الإنكليزية والبرتغالية. أما ابني كامران فإنه ما زال يعيش في ألمانيا، ولم يتزوج قط، مُدمنٌ كحولي، ولا نتواصل إلا مراتٍ قليلة كل سنة أو سنتين.
أعيشُ هنا بهدوءٍ معقول، كشخصٍ كردي، وابن لطبيب/حانوتي أرمني، وأب لرجلين ألمانيين، وجدٍ لحفيدين أمريكيين لم أرَهما قط، وأغلب الظن أنني لن أراهما، بالضبط كما لم أرَ أشياءَ بسيطةً وعادية كثيرة جداً طوال حياتي.
الجمهورية